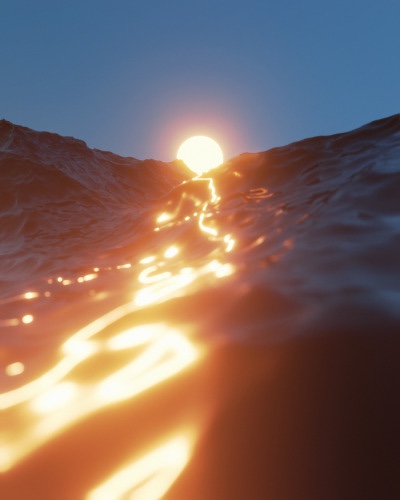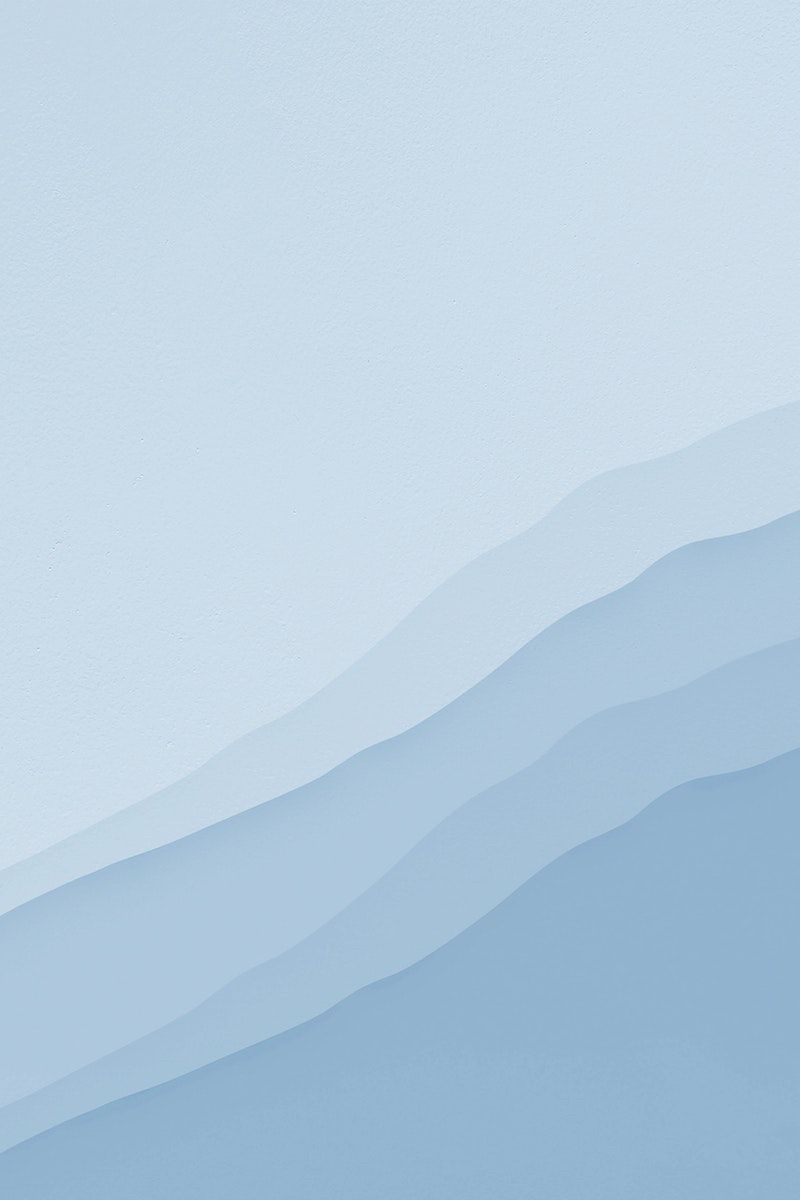هذه نصوص كتبتها متقطعة ولكنّ دافعها ومحفزها واحد، لذلك أحببت أن أجمعها كلها معا حتى لا تفقد نسقها ونفَسَها الواحد، وهي أناشيدُ صباح في مديح ذكرى أو اقتباس لقطة من مشهد.
١
دون حاجةٍ للاتفاق، لعبتُ مع حمامة الصباح لعبة لا معنى لها. قلتُ في نفسي؛ كلما رفرَفتْ حولَ شُبّاكي أنشدتُّ بيتا من الشعرِ أحفظه، بيتا لا يشبه الذي يأتي بعده ولا الذي سبقه، ولا يرتبطُ به في حالةٍ وموضوع، ولا يشتركانِ في لذّةٍ أو اسم. ولأني لا أحفظُ الكثير، وأضربُ أحياناً شطراً بشطر، وأخِلُّ في الوزن، وأفسد القافيةَ والنغمة، وأخلط بين قيسٍ وقيس وصدرٍ وعجز، وأجرّد بيتا صوفيّا من قُدسيته، شعرتُ بالخجل عندما انتهت أبياتي. ورحتُ في تطوافِها الأخير أُنشِدُ بيتَ رجاءٍ عذبٍ حفظته قبل أسبوع وما مرّ يومٌ دون أن أردّده وأغنّيه، وأملتُ في رجائِهِ الخلاص، واستسلمت. ثمّ طارت حمامةُ زوسكيند بعيداً، ولم تعُد، فنسيتُها وأعدتُ الأبيات إلى ذاكرتي ودفنتُها هناك. لكنّي وبعد دقائق قليلة سمعتُ وراءَ الجدارِ مباشرةً جناحين يصطفقانِ في الهواء. فتأكدتُ من خسارتي، وذبُلت، لكنَّ الراوي في رأسي مدَّ لي طرفَ هذا الخيط، سلّمني هذا الاستهلال الغائِر في الروحِ قبل الذاكرة. وبدأتُ أهذُّ القصيدةَ العينية دون انقطاع:”لا تعذليه فإنّ العذلَ…” وما إن وصلتُ:”كأنما هوَ في حلٍّ ومُرتحلٍ..”حتى رأيتُ الحمامةَ تحلِّقُ بعيداً، وتذرعُ فضاءَ الله.
٢
أحاولُ تذكّر مشهدٍ افتتاحيّ لأحد الأفلامِ التي أحبّها. أي مشهد، أيّ فيلم، أيّ حوار. ولا شيء يجيء. ولا صورة، ولا كلمة. لكنَّ عينين_فجأة_تستيقظانِ فزعةً بسبب مشهدٍ غرائبيّ ومُريب(ربما لا عينين، ولا نباهة، ولا بطّيخ ولكن لأني شاهدتُ الفيلمَ هذا قبل يومين)يبدأ الفيلم، بأُذنٍ مقطوعةٍ ومرميةٍ في حقل. لكن وقبل أن أسترسلَ في التذكّر وأذهب بعيداً، وأرى كيف يذهبُ بها إلى الشرطة. أدسُّ رأسيَ تحتَ المخدّة، وأُصغي بأذني السليمة إلى شتائمِ الكوكب، وأسمع صوتَ المحيط الهادِر وكأني أُلصِق بأذني صَدفةً، وأسمع صوتَ أبي وأسلافي، والنغمةَ الفاتنة للكون، والطنين/الأزيز الأبديّ للبيوتِ التي أسكُنها، وأسمع تهاليلَ الفرحِ بمجيئي وأجدها شبيهةً بصوت النعيّ كما قال أبو العلاء، وأسمع هواجسَ الموسيقيينَ دفعة واحدة وأسرارَ الحياة، وأسمع الغزلَ الرخيص في أذنِ الطفلة الخبيثة، والفضائح والكلمات التي لم أتعلّم بعدُ كيف أنطقها، وصرير الأبوابِ كلها، وكأني غرقتُ في ألفِ حُلمٍ وحلم. أقول لنفسي، ربما كانت هذه الحكمةُ من بُعد البدايات واستعصائها واستحالة تكرارها. ربما كانت البداياتُ أقسى حتى، من يدري! أحاول أن أستعيدَ مشهداً آخر، أشردُ، طويلا، ولا شيء.
٣
قضيتُ صباحي في تتبّعِ سنةٍ من السنوات واستجلاءِ أسرارها. هذه العادة التي التصقتْ بي لا أذكر متى ولماذا! لكنّها تعاود الظهور وكأنها موهبةٌ خفيّة ونادرة. أجدُني أضع تاريخَ سنةٍ عشوائيّ في محرك بحث قوقل، وأبحر إلى تلك الضفّةِ المجهولة. أدخل ويكيبيديا كأيّ باحثٍ عن معلومة، لكنّي أراوغ تلكَ الصفحة، وأظلّ مثل ضيفٍ ثقيل جاثماً على صدرها. أرى الحروب وثوراتٍ أُطفئت، ونزاعات واتّفاقات، انهيارات ومصائب، ودخان يعلو حتى يحجبَ الرؤية. وأرى من ماتوا في تلك السنة. ومن ولِدوا تلكَ السنة أيضاً، أنظُرُ إلى وجوههم، وأخمّن بلادهم، وأحاول أن أجدَ نزعةً أو صفةً أو حياةً مُشتركة بين اثنين منهم. أتعمّد أن أزورَ بلاداً زاروها، وأتتبّعهم مثل ظلال، علّ أحدهم يلتقي بآخر خفية، فأقع بفطنتي ودهائي على القصةِ التي قيّدتْ اثنين من أصحابي معاً. أقرأ أسماءهم جميعاً، وحينَ أمرُّ على اسمٍ مألوف، أدخل صفحته، وإذا بهِ هوَ، هو من أعرف، بلا شك. أشعرُ حينها أني أوّلُ من بشَّرَ أهله بوصولِه. عندما أملّ، أو يصيبني التعب. أتوقّفُ عن التجسّس. وأعود إلى حياتي، وورائي أُغلقُ بوّابةَ الزمن.
٤
على السقف لي صورةٌ تتحرك معي إذا حركتُ يدا أو ملتُ مع الصَبَا والأغنيات. دون أيّ مجهودٍ يُستأنَف هذا التناغم العجيب بين مرايانا. تستفزني بالتحديق وأعذّبها بنظرةٍ باردة. تقضي وقتها في التبرّم والتأفف وأترفّع عنها بتجاهلها. بيننا بلدان وجبال ومرايا وسماء ورؤية ضبابيّة ناعسة تمنعنا من التواصل أحيانا. إذا أكلتُ شيئا شاركتني وإذا قرأتُ قلّبت معي الأوراق، ولو صرختُ متأثرا بعُربَةٍ أو بيت ظلّت تعيد الصرخةَ عليّ حتى أنتبه لها امتنانا. وإذا خلعتُ قطعة من ملابسي فعلتْ مثلي وإن تماديتُ تمادت حتى يخجل أحدنا من الآخر ويكفّ. صورة بريئة عندما تستلقي على سريرها العلويّ ونتبادلُ النظرةَ نفسها مثل خيالين في بال. وشرسةٌ عندما أطفِئ النورَ وأتركها معلّقة المصير هناك مثل قطّة شرودنجر. أخرج من الغرفة وأقول لنفسي بأني إذا عدت فلن أجدها في انتظاري. ومن أنا؟ لكنها هناك، وأنا العائد إليها”وما بين عيوني إلّا هي”. أحدّثها فلا أجد منها إلا التطمين والبُشرى، وتحدّثني فلا أسمع منها إلا ما يدور في نفسي. توأم سرّي كنّا في دنيا العجائب. فتحتُ عيوني هذا الصباح على لوحةِ السقف الأثيرة فلم أجدها مكانها، فظننتُ أنها اختفت دونَ أن تودّعني. قلبتُ الوسادة، نمـتُ وعلى لساني:”حتّى لعمري كِدتُ عنّي أختفي*”
٥
بعد القلق من المآلات المتاحة والمصائر الاضطرارية وبعد أن تجفّ الأنهار وتهوي الجبال وتذوي الأزهار وتمّحي آثار الواقفين على الأطلال من غرفتي السحيقة أكثر من مغارة وبعد أن تستقرّ القصيدة وتجد التقسيمة قفلتها وتنتصبَ في البال صورة لعوبٌ وبعد أن تعثر الغرفةُ على لحظتها الساكنة أغفو، ودونَ حيلةٍ، أتنبّه إلى أني قد ورثتُ عادةً أخرى من لازمات والدي؛ حين يترك ذراعَهُ اليمنى معلّقة في الهواء وينام، أغفو هذه المرّة واعيا بذراعي، تاركا لها حقّ الاختيار؛ إمّا أن تظلّ واقفة كشراع سفينةٍ تؤرجحه الرياح، أو أن تخرّ كشجرةٍ مرّة بعد مرة، أو لعلّها تميلُ كغصنٍ فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أغادرها ماثلة كزاويةٍ قائمة ولا أتدخّل في شؤونها، قد تكون مالَت برأسها قليلاً إلى الوراء وأصابعي الخمسة كأنهنّ وريقات وردة مُهداة إلى مجهول، أو بقيتْ متيقّظة وحذرة، ناهضةً كعمودِ معبدٍ أو إنارة وفوقها كفّي الصغيرة مثل عصفور، طامعةً وتائقة إلى شيء لا يُرى. ذراعي النحيلة الممتدّة كفتيل، تنفذُ عبر الفضاء ولا يوقفها شيء، وعروقها المتشابكة تشي بأسرارِها ولا أُصغي. أتركها هكذا، وأعود إليها بعد النوم وبعد أطوارِ الحلمِ الكثيرة وألقاها على حالها. كأني لم أنم، وكأني لم أرها قبل لحظاتٍ تنهارُ وترتطم بحافة السرير وإثر ذاك ينتهي العالم.
٦
من الضجرِ أو من أمورٍ أخرى أقلّ تعقيدا أغنّي مثلما تغنّي السيدة في لوحة صغيرة الحجم على الجدار أمامي. أغني ولا خلاف بيننا إذ تظنّني واحدا من عشّاقها اللا نهائيين فرِحا بهذا التقاطع التاريخيّ، وأحسبها فردا من أفراد الجوقة التي تحمل عنّي أخطائي وتمحو ورائي آثار النغمات الناشزة. أغنّي، ولا أعلو بصوتي حتى لا أوقظ الجيران ولا أنزل فأنبّه الشياطين الغافية في الزوايا. مثل خبيرٍ وعارف بالمقامات أشدو وأتنقّل من طبقة لأخرى وأحـطّ كما ينبغي وأسترسِل كيفما كان، أعتني بقفلاتي حسبما أرى وأسنّ قوانيني الجديدة وأختم كما أشاء. الجدران حولي تنبض بموسيقى خفيّة وأنا وحدي في الصباح غِرّيدٌ لا شبيه له. أنهضُ استجابةً لإحساس مُختمِرٍ لأُكمل ارتجالي الحياتيّ، أستحضِر موّالا وأمشي في أرجاء الغرفة لا خوفَ عليّ، أغنّي وأُفاجأ بمساحاتٍ جديدة في صوتي، مساحات أضيق من فسحة عصفورٍ في قفص، أخرّ هامدا على أرضية الغرفة الباردة، وحيداً دونَ أن يراني أحد، وحيداً إلّا من نظرة دافئةٍ للسيدة الغائبة في غنائها، تستقرّ في عيني مثل وداع، وأموت، وحيدا.
٧
ظلّت مكتبةُ والدي تكبر معي في طفولتي ومراهقتي حتى ظننتها أمَّ النوادر. لم تُبقِ كتابا ومجلدا إلّا وأفسحتْ له المكان. ربما تخملُ مع الوقت وتُنسَى وقد تموتُ، لكن، ليس إلّا لكي تنبعث من رمادها كأنها العنقاء. كلما جالست أحد أقاربي وأرادَ أن يكسر الحواجزَ ويطوي المسافات ويزيلَ الغشاوةَ عن عينيّ حدّثني عنها بنبرة العارِف، فأُسلِم نفسي مجاملةً لمتوهّم المعرفة وأصغي بابتسامةٍ متلهّفة وذهنٍ شارد. يروي لي سيرة هذا الرجل الغريب عنّي ويقصّ عليّ أخباره ويصعقني بحكاية المكتبة البعيدة وهي تتكئ وتميل مع مرور السنوات على جدار بيتي الأوّل والأقدم حتى يكاد ينقضّ. المكتبةُ التي دأبنا على حمل كُتبها وكُتيّباتها في صناديقَ كلّما صَغُرت كانت أعصى على الحمل وانجذبت إلى الأرض كصخرة. كنا ننقلها من بيتٍ إلى بيت ونفرزها ونرتّبها الأثقلَ فالأخفّ حجما ثمّ نعيدها إلى أرففها أو أقفاصها؛ بعدما تموضعتْ، وأخذت مكانها. كتبٌ بحثت في صباحاتٍ متفرّقة؛ تلك الصباحات التي كان فيها المزاجُ طافيا بل عصفوريّا كما أحبّ أن أسمّيه. واقفٌ على البرزخ بين الصفاء والجنون وليس في بالي سوى بيت للسديري(المستريح اللي من العقل خالي-ما هو بلجّات الهواجيس غطّاس)عن موضوع أو صنف يروق بين هذه الكتب وهوامشها وحواشيها وشروحاتها، واللفظة التي تُحيلني على أخرى؛ فأتكاسل عن قراءتها. حتّى صباح قريب تراءى لي فيه ديوانٌ بغلافٍ مستعار من زُرقة الفجرِ الدافئة. كتاب صار ينام تحت رأسي من حينها. أقرأ منه مقطعا، وأحيانا أتتبّعُ فيه قصيدة إلى مصبّها، وبيتا لا يزالُ ينأى في خيال الرواة والأهل والأقارب.
٨
يُخيّل لي أن جدران الغرفة تزحف نحو بعضها بدأبٍ خفيّ لا تُلاحظه عيوني المثبّتة عليها منذ البارحة ولا تستشرفه جزيرةُ روحي المحاصرة من الجهات كلّها. أذكّر نفسي بأنني لستُ الضحيةَ في الفيلم، وأنني قد أُطحن بين مترادفتين أو حالين أو انتمائين يُحييهما سؤال الطفولة البعيد:”لكن، من تحبّ منهم أكثر؟”لكن بالتأكيد، ليسَ بسبب الجدران. وأطمئنُ نفسي، بأنّ الجدران مثل شمس المغيب، لن تغيب تماما إلّا أن أشيح بنظري عنها، وكذلك هي لن تتخطّفني إلا في لحظة سهو، وفي ذلك عزاء. وبعد هذا، مع كلّ شهرٍ يجيء أتعذّر بترتيب الملاذ، وأقرّب قطع الأثاث حتّى منتصفه، السريرُ في نقطةٍ عمياء عن مكيّف الهواء استجابة للعظام، الخزانةُ تناهض الاتكالية وتنتصب شامخة وحدها، الطاولة الصغيرة بأطرافها الحادة وحمولتها الخفيفة تتبعُ النعشَ البدائي وذراعي المُحلّقة. حتى تتوسط الغرفة وأنجو بنفسي. أستلقي، وفوق عيني أرى ترِكَةَ أصحاب المنزل الأوائل حديدةٌ على شكل رمح يتدلّى من السقف. بدءا من الشهرِ القادم، سأُعيد الأثاث بالتدريج، لعلّ إحدى هذه الكوابيس تضلّ طريقها أو أضيع طريقي إليها.
٩
سارحا صباحا في نقطة زرقاءَ مستحيلة أهذي بأصدقاء محمد عبدالباري أتمتم مرةً مقطعا من القصيدة:”تكلّموا قبلَ تاريخِ الشفاه، معي..”وتارة أتركها تسيلُ في داخلي، إذ فجأةً يتسرّب صوت مألوفٌ عبر الأثير، هو ذا صديقي وهي ذي صاده التي تشبه الصريرَ وعينُه التي لا تزال تتسعُ في الغياب. لشدّة نحوله هذا الطفل؛ لم أظن أنه سيخطر على بالي. أمام إشارة حمراء حيث تذوب الاختلافات والفروق ويشترك العالمُ بمن فيه معي في لحظة شرود مكثّفة، ولا يُمكن أن يسحلني شيءٌ من فردوسي غير هذا الصوت. أتخيّله مثلي طاويا ليلته الماضية وساهيا في لحظة بعيدة حيثُ كنّا طفلين نحيلين في زوايا القاعة يتسابقان على تلاوة اليوم. وأنا هنا-على بعد مئات الكيلومترات-في مركبتي التي تنتفضُ من الحُمّى وتشكو مفاصلها أستمع إلى تلاوته المتأنّية وأحرفه العميقة، وأكادُ أحلف أنه سيضربُ بيده شاشة المُسجّلة بعد أن يسمع صوتا خارجا منها يُنادي:”يااا عبدالرحمن”
١٠
والصباحُ غافٍ وراء الشبابيك. والصباح حلمٌ أدخله مع الناس وأغادره وحدي. وضوء الصباح يُعبّئ النقاط الفارغة في الزجاج وينفذ عبرها كعيونٍ شاخصة بعد أن كان الليل يسدّها من فوق عتمة الغرفة الخدرة. أتذكّر ليلة البارحة، وكيف استيقظتُ بسبب السكون الغريب خفيفا وديعا، ريشةٌ تتنزّه في الهواء، حتى وإن شدّتني قدماي المتثاقلة إلى مصيري وأنا أفتحُ بابا بعد باب في البيت الخالي. لا صوتٌ ولا نفس. أنادي بهدوء مُمتنّا لهذه اللحظات الصامتة التي لا تُعاش مرتين. وأحاول كمخمورٍ استعادةَ ما حصل قبل النوم، أيّ حدثٍ وأي توصية على جرّة الغاز المفتوحة أو ضوء الممرّ الخارجي أو حياةٍ تورّطتُ بها بين يدي. إلى أن يصلني هذا النداء الأليف؛ يرنّ هاتفي على بعد ثلاث غرفٍ وخمسة أبوابٍ مُشرّعة، وصوتٌ يقول بأننا في الخارج وسنتأخر في العودة. لا آكل ولا أشربُ شيئا ولا أمشي خطوة أخرى. أستلقي على سريري منفايَ الأوسع، ساقاي ممدوتان إلى ما لا نهاية وإحداهما فوق الأخرى، الليل وراءَ النافذة، يعبرُ بُلدانا لا أعرفُ أسماءها، والأهلُ بخير وعمّا قريب، عمّا قريب سيجيئون. وأنا آملُ أن يتوقّف الوقت هنا، وأن تظلّ الساعة كما هي، العاشرة والـنصف، والأهل سيجيئون، والعالمُ غارقٌ في سكونه ولا يدري.
١١
ليتني أترك ورائي هذه الأمنيات المستحيلة والكُتيّبات خفيفةِ الوزن على الطاولة قُرب السرير والأحلامَ التي تعلّمتُ أخيرا كيف أحتال عليها وأدخل من بابها الخلفي فلا تتهيّؤ لي مجاملةً ولا أرتطمُ بسخريتها الفجّة والعيونَ التي ستظلّ غريبة عنّي وعليّ. ليتني أضعُ هذا الصباح خلفي وأتبع نصيحةَ ابن منير:”أفلا فليتَ بهنّ ناصيةَ الفلا!”حادياً همومي ووساوسي وعلَلي الخفيّة، ذاهبا إلى أبعد ما يكون. ليتني أغذّ السيرَ فلا أقترب من المجهول ولا أبتعد عن مكاني خطوة. أتعلّم كيف أعلّق نظرتي على نقطة لا يراها غيري وكيف أصغي بخشوع إلى النداء الحقيقيّ. مدفوعا برغبةٍ ضليعة تتودّد إليّ كل صباح أخرج من هذا الباب إلى أبواب كثيرة ومن هذه الكلمات إلى صمتٍ خالص ومن الفضول تجاه الأشياء والأسماء إلى فضول لرؤية آخر الدرب التي راحت تتقلّبُ تحت قدميّ. ليتني أجدُ الشجرةَ النائية اليتيمة حيث نمتُ تحتها مرّة في حُلم، ولمّا انتبهتُ حرّكت أصابع قدمي فلم أشعر بشيء، وقرصتُ بيدي يدي ولا شيء، ولم أكن أنا أنا، ولم أعرف أين ذهبتُ.
١٢
منذ أوّل نبوءةٍ وأنا أطارد الصباحَ بكاميرا هاتفي المغبّشة من رأس شارع إلى زاوية ومن تلّةٍ إلى حُمرةٍ مُسالة بعناية وراء البنايتين المتلاصقتين كتوأم سياميّ؛ هناكَ أقف وألتقط اللحظةَ التي ستكون بعد سنتين أو ثلاث صورة مشوّهة لذكرى جديرة بالاحتفاء. بالغبارِ في قدميّ الخدرَتين من المشي. أُطارده بفيلم وقصة، بقصيدة أوشِكُ أن أحفظها وأهذّها على مسامع النَدَامى في الغرفة الخالية وهم ينوسون برؤوسهم. بمتعةٍ ناقصة، وطرفة بسببها ظللتُ أتدحرج طوال النهار، وهذيان واردٍ أبدا. أطارده بذراعيّ اللتين مذ بدأ وهنّ يدرن كمروحتين في الفراغ. بلساني الناقم يفتتحُ حفلةَ الشتائم اليومية، وبصمتي السخيّ يسومني بعد كل كلمة أنواع العذاب. منذ الصباح وأنا أطاردُ صاحبي الذي يجلسُ أمامي ضيفا على كرسيّ في مقهى، محاولا أن أشرحَ له؛ لمَ قد يعني أي شيءٍ لأيّ أحد! أمسحُ من على وجهه الدهشة الباهتة ومن ورائِهِ أرى الليل ببطء متعمّد وساخرٍ-على الزُجاج-يُرخي سدوله ويصيح.
١٣
غرفتي عاصمةٌ ثانويّة للبيت. مخزنٌ لما يفيض من الأشياء والذكريات. في خزائنها الضخمة بقايا متكدّسة من تجارب العائلة البسيطة ومواهبها المنسيّة ودفاتر طفولتها وزجاجات فارغة لعطورٍ قد توصلكَ لذكرى غائرة لو تتبّعتَ رائحتها بأنفكَ وظنّك وسرحت في العماء. وفي حقائبها الملقاة على ظهرِ الخزائن كالهوادج قطعُ ملابس أثرية من عصورٍ سالفة يظهر أن التخلّي عنها مستحيل وهو يؤجَل كل عام. وفي زواياها المرتبكة آلاتٌ لم يحِن بعدُ موسم استخدامها. تبدو مثل مدينة عتيقة تجاهلها التاريخ. إذا مددتُ يدي عشوائيا في أيٍ من خزائنها، لستُ أدري بمَ تعود، قد أُخرِج منها أرنبا أو فيلا أو ربما تظلّ عالقة هناك في فمِ وحشٍ أو تحت مخلب طائرٍ قرأت عنه قبلا ورأيت عينيه تلمعان في عتمة الغرفة غير مرّة. إذا مررتُ بجانبها سمعت ذلك الإنذار الرتيب يحذّر من منطقة محظورة. وحين أسكن إليها بعد يوم طويل أستطيع أن أرى على حيطانها لوحات فيلم”أفضل عرض”وأسمع فيها نغمة عذبة. خطرَ لي هذا الصباح خاطرٌ فعرّيتُها من سجاجيدها وأسرّتها وصرتُ أنتظر الشمس ترتفع ويغطّي ضوؤها الغرفةَ فتظهر لي حينها الإشارات السرّية على بلاطها وتُعرّفني على الأسرار التي ليس لها سواي. أحرّك قطعتي الآن، وأترقّب صامتا حركتها التالية.
١٤
لعبةُ الصباح. أكون في غُرفتي وفي رأسيَ الغرفةُ التي لستُ فيها. على نوافذها الضبابُ وبابها مفتوح على ممرّ يطول. حيطانها ملأى بوجوه أحبّها وأخرى ضيّعتُ فيها أيّامي*، أتأمل بعضها وأغرق مثل نرسيس، وأكدّس للأخرى سيَراً ذاتية في المكتبة الشامخة وأحلفُ أنه سيجيء وقتُ قراءتها. أغلفة مطبوعة لأفلام، قُصاصات صغيرة لشطرٍ أو وصية، صور لشعراء جاءوا من منافيهم ومن آخر الدنيا ليتجمّدوا في هذه اللحظة الأبدية، إيستيلا وورن وشَفَتها العليا التائقةُ مثل أبي الطيب إلى شيءٍ جلَّ أن يُسمَى، معذَّبون مدانون في دائرتهم الفارغة وعيونهم مثبّتةٌ على العبد الفقير. فراشةٌ أو ظلّ فراشة على الجدار. السرير غيمة والغرفة برجٌ عاجيّ. وأنا لا أملّ من الركض في متاهتها. موسيقاها ذاك البردُ الناعم يسري في الأطراف وسكونها الدفء الخفيّ حين يغشاني. أضواؤها كسلى وكرسيٌّ في إحدى زواياها يطلّ على العالم من نقطة مجهولة. والرائحةُ فيها عطرٌ يذوب في الحكايا وينتشر فجأة في الجوّ وأنت تمشي في أمان الله. أسمع فيها صوت فدوى تُغنّي النونية:”فانحلَّ ما كان معقوداً بأنفسنا”وأجيبها:”وانبتّ ما كانَ موصولاً بأيدينا”وإذ بقدميّ تهبطان على السجادة الرمادية العتيقة وعيوني تتفتّح على الحائط الأبيض ونقطةٌ أخرى عابثة تثير انتباهي توّاً.
*إن كان منزلتي في الحُبِّ عندكمُ-ما قد رأيتُ فقد ضيّعتُ أيامي. ابن الفارض.
١٥
في كلّ عام أشدّ رحالي إلى أقصى نقطة في الأرض. أركب سيّارتي الهذّاءة وأنطلق بلا يدٍ تودّع ولا عينين تأملان الإياب. أغيب في قلب المدينة ومتاهتها متّجها إلى بيت ينأى كلما دنوت. لكنِ الطريقُ لا تخدعني ولست أجاهد في تتبّعها، إنما أطويها كيفما جاءت، ويدلّني إلى الوجهة ذلكَ العهد القديم. أمرّر ذراعي في الهواء البارد وأشقّ الزحام بالأغنيات. أشرد في الزرقة الحالمة وتنبّهني شتيمةٌ أو زمامير لاعنة. أمضي وكأني قطعتُ نصف المسافة وكأني قطعتها قبل عشرين دقيقة وهكذا، لكني لستُ ضائعا على الأرجح ولا مستعجلا على الوصول. ربما خيّبتني الخيالات، لعلّي بعد مشوارٍ طويل رفعت رأسي عن المقود ولم أجد البيتَ أمامي، أو طرقتُ أبواب بيوت الحارة فلم أعرف أحدا ولم يعرفني أحد. أتجاهل هلاوسي، وأنتظرُ متى سيلفظني هذا الصباح أمام بيتي القديم ويتركني هناكَ كما الآن، مستنداً على مؤخرة سيّارتي كشجرةٍ وشجرةُ البيت الأسطوريّة نفسها تميلُ على جدارِهِ، ونحنُ ننظر نحوَ بعضنا بلهفة غريبة، وأكاد أسمعها تقول: عرفتك.
١٦
في نواة هذه الحيطان المطلية بالخدوش أسرارٌ مُخبأة، رسائلُ ووصايا للأحياء الذين سيجيئون بعدي ويصدّقون ظنونيَ الرخوة. انتصابها المسترسل يشدّني إلى أعلى ووراء لمعانها الباهرِ عيونٌ محبوسة في حسرتها، وفي ارتجافها الرتيب صرخة لا يصلني غير صداها. وراءها أنهارٌ نزلت فيها وبحيرات جلستُ على ضفافها وأيدٍ كثيرة تضرب في فراغ. ومثل من يقف خلفَ المرآة، خلفها يقف، ولا تلتقي نظراتنا إلّا في لحظة غفلة أو هُدنة. تحفظني داخل صندوقها الأثري وتطلق عليّ أشباحها ليلا. سجينُ دوارها الدائم وحائر بسبب أبوابها المطموسة. أتوسّطها مثل نقطة على صفحة من بياض، وأشقّها عابرا تارةً أخرى مثل سهم ناقم، ثمّ أتركها وحدها مع فضائحي وفوضاي. الحيطان التي تنبسطُ على جهاتها الأربع في الشرود وتُريني ما تخفيه من بلاد وأسرار ومعجزات، وفي لحظة الصحو تكاد تثبُ على صدري. في قلب هذه الحيطان قُرَى صغيرة ستفنى، بعد أن تهبط عليها من السماء كرةٌ إسفنجية كنت أمرّن بها ذراعي منذ الصباح برميها نحو الحائط؛ ستختفي في العدم، وتنسى هذه المرّة أن تعودَ إلى يدي.
١٧
منذُ الفجرِ وأنا أدور في فَلَك نفسي. أعيشُ حياتي وأحفر في إثرها. أنا قصّاصُ الأثر، أدور حول نفسي مذ عرفتها. لا يُغيّرني طارئ ولا تغويني رغبةٌ في اجتهاد. أتبع خطاي نفسها وأمشيها كما كانت بالأمس. ما خرجتُ إلّا بسبب هذه الزرقة المستحيلة، جاءت من كل مكان، وقفتْ على زجاج شُبّاكي وحيّتني واستأذنتني للدخول، فحيّيتها بأحسن منها أو خُيّل لي. غادرتُ غرفتي وأغلقت على يدي الباب، وكنت أُحسّ وأنا أغلق البابَ على يدي أني سأفعل. تركتُ المدينةَ ورائي ومشيت نحو بشارةٍ تومض في السماء. داخلاً هذه المتاهة التي تتكشّفُ لي بعد كلّ مرحلة من مراحِلها، فأعرف سرّها مرتين. أدور حول نفسي في رقصةٍ درويشيّة لا تنتهي وفي رأسي تدور البلاد والأوهام والرؤى وعميقا في العينين تدور عينا إيستيلا وورن كأنها مركّبةٌ أحداقها فوقَ زئبقِ*. مسافرٌ في رحلة لولبية من الفجر وحتى وقت ذبول الأقدام والخدرِ اللذيذ في الأطراف والشرارة الخفيّة تبرق بين العظام. أدور مع أنصاف الحكايا والأغنيات مثلما يستمرّ(الطوطم)بالدوران على الطاولة في الفيلم، لأنّي لا زلتُ في سريري أحلُم وأتخبّط وأهوي، ويبدو أني-كالعادة-أضعتُ المخرج.
*أدرنَ عيونا حائراتٍ كأنها-مركّبةٌ أحداقها فوقَ زئبقِ _المتنبّي.
*الطوطم. من فيلم inception. هو أقرب للعملة النقدية، يُديرها الشخص فإذا استمرّت بالدوران علَم أنه يحلم، وإذا توقّفت بعد قليلٍ علم أنه ليس كذلك.
١٨
خيالي هو ما يُبقي الغرفةَ على حالها. طافية فوق بحر من الهلاوس والرؤى. محمولةً على جناح فراشة وحائرة بين الجهات. خيالي هو ما يُسمّي الأشياء الساقطة من علوٍ في الغرفة نيازكَ ويرى المساحات الفارغة ينابيعَ وضفافا. ويعوّل على ما وراء الباب؛ موسيقيٌّ قديم يبحث عن نغمة أو شاعر ظلّ يصرّ بحثا عن خاتمة حكاية متمنّعة. صباحا على السريرِ رأسي مكان قدميّ هذا النهار. السقفُ لفان غوخ والمرايا لدالي. وما الذي يبقى لي حينَ أصفرُّ كدوّار شمسٍ ولا أرى في المرآةِ سوى عينين تدوران كمجرّتين ولسانٍ يتهدّلُ كعصفورِ ساعة من شدّة الإعياء. صباحا على السرير لي وجه شارِد مع السرب وذراعان كطائرين مقيّدين إلى جسدي وساقاي عكّازتان للأيام المريبة. لي أذنان تتخاطفهما نداءاتُ غرباء وموسيقى مروّضة، وجسدٌ لا يقلقه الهدوء المُبشّر بالطوفان. لستُ أمدّ ذراعي إلّا جسرا تعبر فوقها المركبات والناس إلى الجهة الأخرى، ولا أحرّك أصابعي إلّا لتبقى النغمةُ حيّة، ولا أُنادي بصوتي لأنّه الحقيقة الواحدة التي ستنبّهني من هذا العالم الحالم، لو بكلمة، أو صرخة.
١٩
كل شيء ثابتٌ أمام عينيّ المغمضة. الصورة المُخبأة أسفل السجّادة. النهرُ في لوحة على الجدار. الخصلةُ العابثة في المُخيّلة. الضوء المرتجف يتأرجح بين حالين وتصطاده نظرتي المحلّقة فيختار جانبا ويسكنُ. صفحات الديوان المتتابعة مثل موجٍ غامر ترفعها قَنَا المتنبّي عاليا وتتطاير في الفضاء. الأغنية الصادحة تتروّى وتطول آهاتها النادمة. الندامى والعفاريت أبناء الزوايا والحكايا السرّية. الوصايا الشجيّة والمنافي والأوطان ولحظةٌ كدتُ أنساها في صباح بعيد. غبار خامد على الرفوف؛ شاهدٌ على الصبيّ الذي أستأمنه على نفسيَ ليلا. المرآة على صفحتها نرجسيٌ خالد. الخزائن الغائبة في وساوسها العقيمة ومستقبلها الراكد. حتى القصة التي على وشك أن تُقال. حتى فراشي المعلّق في الهواء بعد أن نفضته أمّي. حتى أمّي، الواقفة في منتصف الغرفة تائهة في التفاصيل ومشغولة في تأجيل المجهول. كل شيء ثابتٌ، هناكَ أمام عينيّ المغمضة، ولي أن أُبقي الأشياء على حالها وأغيب، أو أفتحهما، وأجرّب_للمرّة المليون_حظّي.
٢٠
وردة على الأرض. نداءٌ مهمل ظلّ يطاردني حتى يئِس وتلاشى. أثرُ خطى تصعب على التخمين. مفتاحٌ وصورة. أغصان وطرقٌ تتفتّح تحتَ أقدامي. رسالة ناقصة. مفازة وينابيع، خطوتان إلى الجحيم وأخرى مثلها إلى الفردوس. أنهار على مدّ النظر، وبساتين تميد بخصرها. قصور بذكرياتها وأيّام طينها. قُرى تنأى بعزلتها. أبواب في الخيال أدخلها أسيرا وناجيا أخرج. أمشي على نغمةٍ في سلم، أهبطُ إلى مقام جريح. حتى السماء تستلقي على بحيرةٍ راكدة في منتصف الشارع. برأسٍ مُطرقة ويدين مقيّدتين وراء ظهري أمشي، مشيَ الفلاسفة وتأمّل المُقدّرين. على الدرب نفسها حيث استرسلت بالأمس ذاهبا وعدتُ هاربا أنقشُ في جلد الأرض رسالة مخفيّة وأترك للنسيم البارد أن يحمل عنّي ثقلي ويدفعني بعيدا. أخالف الجهةَ التي سلكتها قبلا وأعود كي أستكمل المتاهة بخيطٍ في يدي. أحمل هذه المدينة وجدرانها على مستوى عينيّ وأثبّت في حدقتيهما عتمتها وأشباحها وأشجارها. لعبةُ هذا الصباح أن أكونَ بعيدا عن الأرض مسافة وثبة وعن السماء بقدرِ ألف نظرة عميقة؛ طائرا حائرا بين الجهات وذاهبا إليها كلّها.
٢١
على ضوء الصباح والأغنيةُ لا تحتمل أكثر من أن تكون ضربة خفيّة تحت العظام. الأغنية جناحُ العالم المبلّل؛ ينفضه في الأعالي فتصيبنا عنايته مثل مطرِ الصيف وردتگ تُمُر ضيف، يدا الخلود تسحبانني من أيّ لحظة وتدفنني فيها، تعويذة الروح؛ إشارةٌ سرّية للتحليق أو الانطفاء فحسب. صباحا والأغنية في فمِ طائر يذرع فضاءَ الله، أو على ظهرِ مسافر وراء هذا الفجر، أو داخل عينيّ غريب. أتذكّر الحالمين والأشقياء، المنسيين والمتورّطين في متاهة المجهول، الباقية وجوههم على صفحة الماء، والماشينَ خلف الغياب مثل ظلّه، ومن قالوا كلمتهم الأخيرةَ وضاعوا، أتذكّر الوصيّة المعرّية:”فاسأل الفرقدين عمّن أحسّا-من قبيلٍ وآنسَا من بلادِ” والعابرين تحتهما، أتذكّر النورسَ المنفيّ جوناثان والبُشرى المضيئة في عينيه، وكلّ من هُم وراءَ هذه العاصفة في البال، ووراء هذه النافذة في الحلم، وأنسى، الكائنَ الأوّل الذي تركَ أغنيته على عتبة باب العالم، وهرب.