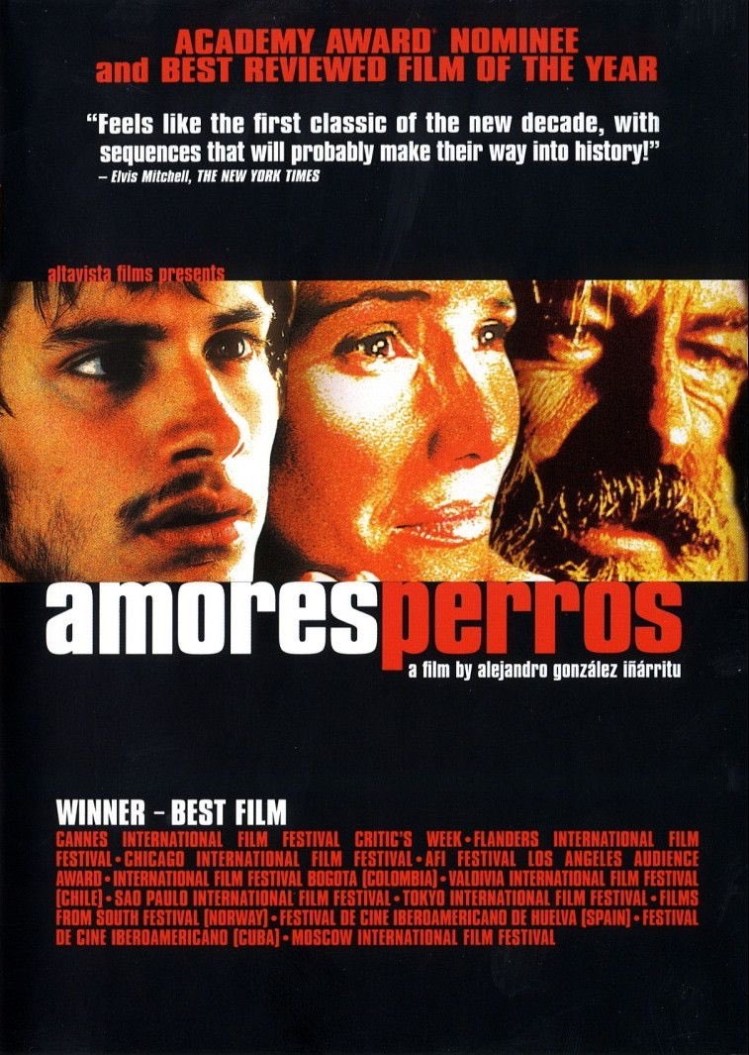“عندك أمل يضوي نجومي في السما؟ عندك أمل يروي، يروي بساتين الظما!”
أمل. اسمٌ مكتوب على كل جدرانِ المدينة وحيطان الحارة، حتى تلك التي لم أدخلها عنوةً ولا حظّاً. له نغمةٌ رشيقة، ورنّة خفيّة ما دامَ اسماً مُجرّداً من معناه وظلّ يجري في نداءٍ بعيد أو رجاءٍ حالم. فاتحةُ المنقوشات على الحور العتيق. أمل، الصبيّةُ الأولى التي وُلِدَ على لسانها وفي صوتها كما يقولُ صاحبي الآشوري* الغناءُ الشرقيّ وبدأتْ تُغنّي وتُغذّي الذاكرة بصوتها العذبِ المُدلِّل. لكل اسمٍ مكان تتذكره فيه، ولا أتذكّرُ أمل، إلّا واقفاً على حافة العالم ونسيمٌ ينفح وجهي، ولا شيءَ يدفعني من الخلف سوى حياتي التي بالغتُ في كرهها. الفجر. هذا هو وقتُ استدعاء أمل وصوتها وأغنيتها الطافية في كل هواء. عندما الصمتُ والهدوء يبدآن بتقشيرِ الماضي حتى يصلا النواة. وتظهر كل الأشياء التي حرصتُ على إتلافها بسذاجة. صوتُ أمل. هو مركز كل هذه الذكريات. وعندما أفقده، سأفقد كل ذكرى أخرى. لكن أحياناً، أشكّ في وجوده، كما أشكّ في وجود غيره من الذكريات.
“وعندك أمل عندك؟ محتاج أمل عندك؟”
أمل. الكلمة الشقيّة اللعوب. ليسَ في تطلُّعها ولا إلحاحها الغريب، ولا في ابتسامتها المخطوطة منذ الأزل على وجهها. ولكن في تأرجحها السلس بين المعاني. كلّما سبق حرفٌ أو تأخر، تبدّى لها وجهٌ آخر. أمل، كائنٌ أسطوري، على الأرجح. وصوتها، ربما صوتٌ من أصوات الطبيعة، يفسّرُه عقلي بطريقته. أو صوتُ هدهدة تنبعث من كل مكان. وتختفي في لحظتها. وربما شخصيةٌ هاربة من حكايا الأمّهات. لها صوتٌ، ولا تراها العينُ إلا بعد أن تسهرَ آلاف الليالي. وقد تكونُ صديقاً مُتخيّلاً مُصطفى، ومرسوماً باهتمامٍ بالغ. أو لعلّها دندنةٌ ساحرة من شوارعِ البلدان التي عبرتُها قديماً، تشرّبتها الذاكرةُ في إحدى أيّام الطفولة، وظلّت تعاودني مثل وهمٍ لطيف.
“المسا اللي ملاه الشوق. ما اسمه مسا. يمكن اسمه عمري اللي ضاع فيك. ولّا اسمه ألف ضحكة تحتريك”
مقطعُ فيديو بشاشةٍ سوداء وصوتٍ نورانيّ. يستمرّ لثلاثين ثانيةٍ وأكثر قليلاً ربما. ليتهُ طالَ بعض الشيء فخلّصني من ورطة الرقمِ ثلاثة. وجنون ثلاثيّة الموت، أو ثلاثية أغوتا كريستوف. وحتّى ثلاثية ابن الفارض وفدوى والجبالي. أو ليته قصُرَ؛ فكان أقلّ من أن يكونَ ذكرى منفردة، وضاعَ في الزحام.
ومرّاتٍ أخرى. ليستْ أمل إلّا فتاة لا أعرفها أبداً. منذُ سنوات تبدو بعيدةً الآن، كانت تُغنّي. على صفحةٍ في مكان ما. وكنتُ أنقلُ لها مقطعاً من أغنية تدندنها، من هاتفٍ لآخر بحذرِ من وجدَ المغارةَ وأُلهِمَ كلمةَ سرّها. وفجأةً اختفى المقطع من هاتفي، واختفى من الصفحة كلّها. وبقيتُ أنا والصفحة الفارغة إلّا من اسمٍ ثُلاثيّ نتسامرُ طوال الوقت كناجيين وحيدين بعد طوفان الفجأة. أُحدّث الصفحةَ، ومراراً أفعل، وأتخيّل انبثاقة المقطع القصير. وأكبسُ على زرF5، ويدي الأخرى على ذقني، آملاً أن يُصابَ الموقع بخللٍ أو بشرودٍ قصير فيعيد المقطعَ مرّة أخيرة. أو تظهر رسالةُ اعتذارٍ على الأقلّ.
“ولّا اسمه قلب عاشق دايم يسمّي عليك”
وأحياناً في الحُلم. أدخلُ على صفحةِ مُنشئ الموقع نفسه، وأراسله مثل صديقٍ قديم. “كيف حالك؟ أتمنى أن نلتقي قريباً، وأنت في صحة جيّدة. اِرسل لي لو سمحت النسخة الاحتياطية كاملة بما فيها..” مع أني لستُ أدري إن كانت هي المطلوبة. وأُرفِق عنوان بريدي الإلكتروني الخاص. ثم أودّعه بحرارة.
–
*كيفَ ولدَ الغناءُ الشرقيّ. سركون بولص.