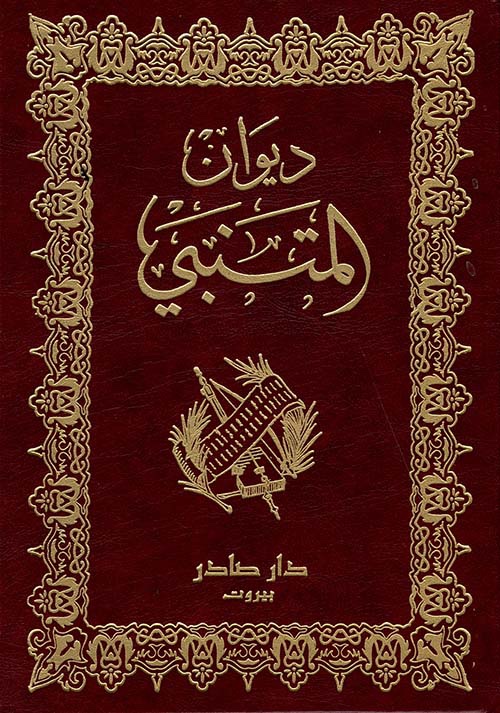
من أبسط وأحلى متع العربيّ لعبته الخاصة مع اللغة، فها هو يستأني ويترقّب ويُنصِت لنغم البحر ويتتبّع حروف القافية حتّى يتوقع القادم ويصطاد الكلمة التالية التي اختارها الشاعرُ ومهّد لها لتقع في هذا المكان تماما. ها هو يُقلّب الألفاظ ويقطّع الأشطر ويحسب احتمالات القوافي وحركاتها ويقيس رنّة ودرجة الموسيقى في المدى ويستبعد الكلمات المكررة والمعاني المألوفة ويفكر بالمتضادات والمرادفات والمعاني وعكسها ويراجع الصورةَ الشعريةَ قبل اكتمالها في سلسلة البيت ويتخيلها ويستحسنها ويفاضل بينها وبين احتمالٍ واردٍ آخر تسمح به القافية مكعّبةُ الاحتمالات؛ كل هذا يحدثُ دون أن يدري وينوي، دون أن يُقرّر التوقف عن السماع أو القراءة حتى، كم من قوالب تفرّعت خواتيمها فقادتْ قارئها إلى فخ التوقعات، وكم من قوالبَ أحكم شاعرها ضبطها فكأنها دربٌ تضيقُ لتفضي إلى جهةٍ معلومة وغايةٍ بعينها. والصورةُ الشعريةُ بالرغم من أنها راسخةٌ مذ كُتبت أول مرة؛ إلّا أنها نبعٌ يتفجّر كلما مررت به، وما أحلى أن يجيءَ الشيءُ على صورته الأصيلةِ كما اشتهيتها وتوقعتها وتطلّعتَ إليها، انظر إلى وجد أبي الطيّب المتمكّن، ثم انظر كيف يتحدّر وينزل حتّى كسرةِ القافية الميمية، واطرب عندها لتخمينكَ الهائل:”وقفنا، كأنّا كلُّ وَجْدِ قلوبنا-تمكّنَ من أذوادنا في القوائِمِ” كأنّ الشاعرَ بمسمارِ الأبدية يُثبّت الصورةَ في مخيّلة العالم، والقارئ والمُصغي تتكشّف له، أو تتراءى، أو يتوهّمها ويُخيّل إليه، ولكنّه على الأرجح سيناله دوما شيءٌ منها، نفحةٌ من شذاها، ولمعةٌ من ضوئها، وفي ذلك كفاية. أذكر أنّي لعبتُ هذه اللعبة مع الجواهري في قصيدة سامراء (ودّعتُ شرخ صبايَ قبل رحيلِهِ) وقوافيها الراقصة المنغّمة، ومن يومها وأنا أحفظها عن ظهر قلب، وأنشدها فيسألوني لمن هي، فلا أزعم أنها لي تماما ولا أنكر حقي في أن تكون لي كذلك.